أمير فخر الدين: أدرس الشخصيّة، وأعالج النتيجة لا السبب | حوار

* الهجرة قد لا تكون هجرة المكان، بل هجرة الهويّة نفسها.
* سوريا هي الشابّ السوريّ الجريح الّذي ظهر على الحدود، سوريا الجريحة الّتي لجأت إلى الجولان الوطن الصغير.
* أفضّل الأدب الّذي يعالج النتيجة لا السبب، والّذي يكون فيه السرد دراسة للشخصيّة.
* يتطوّر شكل الاحتلال العسكريّ إلى احتلال معرفيّ، ولا تعود المشكلة في الجيب العسكريّ، بل في الاحتلال المعرفيّ الّذي يهدّد الهويّة الجولانيّة.
اخْتِيرَ فيلم «الغريب» (2021)، من إخراج وكتابة أمير فخر الدين، لتمثيل فلسطين رسميًّا عن فئة الفيلم الروائيّ الطويل الدوليّ (غير الناطق بالإنجليزيّة)، في المنافسة على جوائز «الأوسكار» في دورتها الرابعة والتسعين خلال العام 2022. جاء ذلك الاختيار من خلال لجنة مستقلّة مهنيّة من العاملين في القطاع السينمائيّ الفلسطينيّ، وبتكليف من وزراة الثقافة الفلسطينيّة.
الفيلم من إنتاج مشترك لعدّة دول من بينها فلسطين، وهو أوّل فيلم من الجولان السوريّ المحتلّ يمثّل فلسطين في «الأوسكار»، وكان الفيلم قدر عُرِضَ للمرّة الأولى عالميًّا في «مهرجان البندقيّة» السينمائيّ الشهر الماضي، كما عُرِضَ في افتتاحيّة الدورة الثامنة من مهرجان «أيّام فلسطين السينمائيّة»، في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).
يتتبّع الفيلم حكاية عدنان، الشخصيّة الرئيسيّة، الّذي يقوم بدوره الفنّان أشرف برهوم، والّذي يعاني من أزمة وجوديّة يزيدها سوءًا شعوره بخيبة والده منه لفشله في أن يصبح طبيبًا.
في هذا الحوار الّذي تجريه فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة، نتحدّث مع المخرج أمير فخر الدين عن خصائص الفيلم الفنّيّة والسرديّة، وعن موقعه من المقاومة الثقافيّة الجولانيّة للاحتلال المعرفيّ الصهيونيّ، وعن العلاقة بين الشخصيّ والفنّيّ.
فُسْحَة: أريد البدء بما هو شخصيّ في فيلم «الغريب»؛ هل ثمّة علاقة بين ولادتك في كييف عام 1991، وما بين عودة البطل الرئيسيّ، عدنان، إلى الجولان من روسيا؟
أمير: عندما عدت إلى الجولان كنت صغيرًا، لكنّ والديّ دَرَسا الطبّ في الاتحاد السوفييتيّ. ليس لديّ ذاكرة من كييف إلّا شهادة الميلاد. أمّا بالنسبة لعدنان، فخلفيّته الشخصيّة أنّه تعلّم الطبّ في روسيا، لكنّه لسبب أو لآخر لم يحصل على شهادته، ولم أُرِدْ في الفيلم معالجة ما حَدَثَ معه في روسيا، لكنّني عالجت النتيجة، أي الأزمة الوجوديّة الّتي يعيشها مجتمعيًّا لأنّه لم يلبّي توقّعات أهله. كما أنّني متأثّر جدًّا بالأدب والسينما الروسيّة، وثمّة أغنية روسيّة دفعتني إلى كتابة بعض النصوص الأولى للفيلم عندما سمعتها للمرّة الأولى، ففي كلماتها ما جعلني أتخيّل لقاءً مع شابّ سوريّ جريح وراء الحدود، والتأمّل في فكرة الحرب الّتي نسمع أصواتها في الجولان ولا نراها. الحرب الّتي تدفع إلى التساؤل عن ماهيّتها، وأين نقف منها، وإلى أيّ درجة يمكننا اعتبار أنفسنا امتدادًا للشارع السوريّ في أزمته. أعددت استفتاءً صغيرًا وسألت خمسين شخصًا ماذا سيفعلون لو ظهر بالفعل شابّ سوريّ جريح على الحدود. الأغلبيّة أجابت بالطبع سنساعده، لكن أيضًا سنتواصل مع الجيش الإسرائيليّ أو الشرطة. هذه الإجابات تقول شيئًا عن الإنسان العاديّ الّذي يخاف على نفسه في موقف كهذا، وضرورة أن يكون البطل شخصيّة مغايرة للعاديّ، وأن يكون مغامرًا مثل عدنان. بالنسبة إليّ، سوريا هي ذلك الشابّ السوريّ الجريح الّذي ظهر على الحدود، سوريا الجريحة الّتي تلجأ إلى الجولان الوطن الصغير. ويُظْهِر عدم تردّد عدنان في مدّ يد العون للشابّ السوريّ شعورًا عميقًا بالانتماء والوطنيّة لديه، وهو ما يتّضح في نهاية الفيلم. عندما سمعت الأغنية الروسيّة للمرّة الأولى، واسمها «إبريل»، وجدت في كلماتها ما يلائم مشهد الثورة السوريّة، المشهد القاتم المليء بالغيوم السوداء، وضرورة أن يكون ثمّة ربيعًا في النهاية، ولذلك استخدمتها في الفيلم.
فُسْحَة: عادة ما يُسْتَمَدّ العمل الروائيّ الأوّل، سواءً كان رواية أو فيلمًا، من الحياة الشخصيّة للكاتبة أو الكاتب، فهل تلك هي الحالة في فيلم «الغريب»؟
أمير: كلّا، لا أفضّل استيحاء العمل من التجربة الشخصيّة، ذلك لا يجذبني بقدر ما تجذبني صناعة فيلم عن المخاوف المستقبليّة، من هناك أستوحي الإلهام أو الفكرة، وأمتنع عن التفكير في تجاربي الماضية. لا يعكس المكان الّذي بنيته في الفيلم طبيعة المكان أو إشكاليّاته السياسيّة، بل يستخدم هذه الطبيعة. ذلك يعني أنّ المكان ليس منفصلًا عن الشخصيّات، بل المكان نفسه يُعَدّ شخصيّة وتُضْفى عليه صفات مكانيّة تحاكي روح الشخصيّة الرئيسيّة المشتعلة. يمكن التفكير بالفيلم ككولاج مشاعر حاولت التركيز على إبرازها جميعًا، وبذلك أعني أنّه حتّى استخدامي لما هو شخصيّ، كان استخدامًا لمشاعر لا لتجارب؛ فوالدي مثلًا لم يشتغل في مجال الطبّ رغم دراسته، وذلك لأسباب مختلفة لا علاقة لها بالفيلم، وأن تقضي سبع سنوات في تعلّم شيء ولا تتمكّن من ممارسته يولّد شعورًا قاسيًا بالإحباط، خاصّة في مجتمعات أبويّة تُعاقِبُ بناءً على توقّعاتها. ذلك الإحباط جذبني بصفتي مراقبًا، وذاك الإحباط حضر في الفيلم شعورًا فقط، لا كتجربة متطابقة بين عدنان ووالدي. كنت واضحًا في عدم رغبتي في صنع سيرة ذاتيّة، بل أردت دراسة الشخصيّة من خلال الفيلم ومتابعة تطوّرها؛ وذلك يعني أنّني لا أعرف شخصيّتي بشكل كامل، مثل عدم معرفتي بالأسباب الّتي منعت عدنان من إكمال دراسته. لا أحبّ التوجّه الأدبيّ أو السينمائيّ الّذي يعتمد على الحبكة السببيّة، بل أفضّل الأدب الّذي يعالج النتيجة لا السبب، والّذي يكون فيه السرد دراسة للشخصيّة. ذلك ما تجده في رواية كافكا «الانمساخ» (1915)، فكافكا لا يوضّح لماذا أصبح غريغور سامسا، الشخصيّة الرئيسيّة، صرصورًا فجأة، بل يتتبّع الشخصيّة ويدرس تطوّرها. ذلك مبدئيّ أيضًا، أي دراسة تطوّر الشخصيّة من خلال العمل بدلًا من معرفتها بشكل كامل. ربّما يكون هذا توجّهًا وجوديًّا بعض الشيء. قد لا أعرف ما يدفع عدنان لفعل أو عدم فعل شيء في مكان ما، وأنا متصالح مع حقيقة أنّ ثمّة أمور معيّنة لا أفهمها حوله، فأضعه في مواقف معيّنة لفهم سلوكيّاته ودراسته مثل موقف إنقاذه للشابّ السوريّ الجريح. في ذلك المشهد ثمّة ثلاثة شخصيّات، وهي عدنان، وأكرم، وهاني. كلّ شخصيّة منهم تمثّل طبقة مختلفة من المجتمع الجولانيّ؛ فثمّة الخائف والمتردّد، والبطل المغامر، أي عدنان.
فُسْحَة: لماذا توجّب على عدنان أن يكون هذه الشخصيّة كي يكون ممكنًا فعل إنقاذه للشابّ الجريح؟
أمير: عندما يذهبون لإنقاذ الشابّ الجريح يحدث صراع بينهم وكأنّهم هُمُ الجولان نفسه؛ فثمّة الخائف الّذي لا يريد المخاطرة، وأولئك الغارقين في الحنين والشوق للوطن الأمّ، لكنّ صبرهم يوشك على النفاد. أمّا عدنان ففي شخصيّته بعض العبث، وذلك شيء أعيه حوله، وفيه شيء غير تقليديّ؛ فهو الإنسان الّذي قد يوصف بعديم الأصل، أو البذرة السوداء، ذلك الّذي لا ينسجم مع الآخرين ويبدو منفصلًا عنهم.
فُسْحَة: أعادني حديثك عن «الانمساخ» لكافكا إلى روايته «المحاكمة» (1925)، والّتي اشتغل فيها أيضًا على بناء المكان كشخصيّة مؤلّفة من عدد من المشاعر بحيث يصبح المكان نفسه شخصيّة من شخصيّات الرواية المركزيّة. عند التفكير في جوزيف ك مثلًا، الشخصيّة الرئيسيّة للـ «المحاكمة»، نجد أنّنا لا نعرف شيئًا عنه، لا قصّته الشخصيّة ولا حتّى طبيعة القضيّة المرفوعة ضدّ وبسببها يُحاكم من قبل محكمة لا نعرف عنها شيئًا أيضًا. كذلك يبدو المكان بأكمله كأنّه قاعة المحكمة، وكأنّه يقع خارج عالمنا الّذي نعرفه ونألفه. بطريقة ما يبدو الجولان في «الغريب» كأنّه يقع بين بين، مثلما هو في فيلمك القصير «بين موتين» (2017). فهل يمكن التفكير بالجولان كمكان كافكويّ بطريقة ما؟
أمير: بالضبط، هذه إحدى التأثّرات الواضحة. أستطيع الحديث عن كافكا، وأيضًا عن جبران خليل جبران وغيرهم. ولكن، عندما قرأت «المسخ» لكافكا شدّني مبناها التراجيديّ جدًّا، وبناء الشخصيّة الّتي تتطوّر من سيّء إلى أسوأ، ومن خلال هذا التطوّر تُكتَشف الذات. وبهذه الطريقة تُدرَسُ الشخصيّة، وتُعالج النتيجة لا السبب في «المحاكمة» أيضًا؛ فنحن لا نعرف لماذا هذا المكان، لكنّنا نرى المكان الّذي تقمّص شخصيّة النتيجة.
فُسْحَة: ثمّة نوع من الحتميّة عند كافكا يتمثّل في انعدام إمكانيّة خروج أيّ شخصيّة أو حيادها عن المسار السيّء، ومسارات كافكا من الصعب وصفها لا بالسيّئة ولا بالجيّدة، هي مجرّد مسارات. أي أنّ ثمّة تتابع في الأحداث الّتي تحدث لضرورة حدوثها وليس ثمّة إمكانيّة لانعدام أو تجنّب حدوثها. هل ترى حتميّة مشابهة لحتميّة كافكا في «الغريب»؟
أمير: ثمّة شيء ممّا تقوله، أنا لا أستطيع إبداء تأويل هنا، وأعتقد أنّ المشاهد بإمكانه تأويل شيء كهذا. لكن أستطيع القول أنّني متأثّر بهذه المدرسة الأدبيّة، وثمّة شيء آخر يتعلّق بالمعالجة الفنّيّة وقيمتها الأخلاقيّة عند خالق العمل الفنّيّ. لنفترض أنّك طبيب نفسيّ، فأنت لن تلجأ مباشرة إلى البحث في الأسباب، بل يتوجّب عليك الاستماع ومنح انتباهك الكامل وقبولك الكامل والبحث من خلال ذلك عن المحفّزات الأساسيّة. ذلك ما يشدّني إلى ذاك النوع من الأدب. ليس فقط عند كافكا، ولكن كامو أيضًا، فثمّة الكثير من العبثيّة الّتي لا تلجأ إلى استخدام العلاقة السببيّة كمحرّك للأحداث. وأعتقد أنّ السينما بالذات فيها إمكانيّة أكبر للهرب من الأسلوب القصصيّ التقليديّ. لذلك ترى أنّ فيلم «الغريب» يتّخذ نمط مطارة الشعور موضع العلاج من خلال الصوت والصورة، ما يمكّن من تجنّب الأسلوب القصصيّ من خلال الإطالة في المشاهد والامتناع عن القطع، وهذه تقنية تمكّن المشاهد من الشعور بأنّه أمام عمل حواريّ لا خطابيّ.
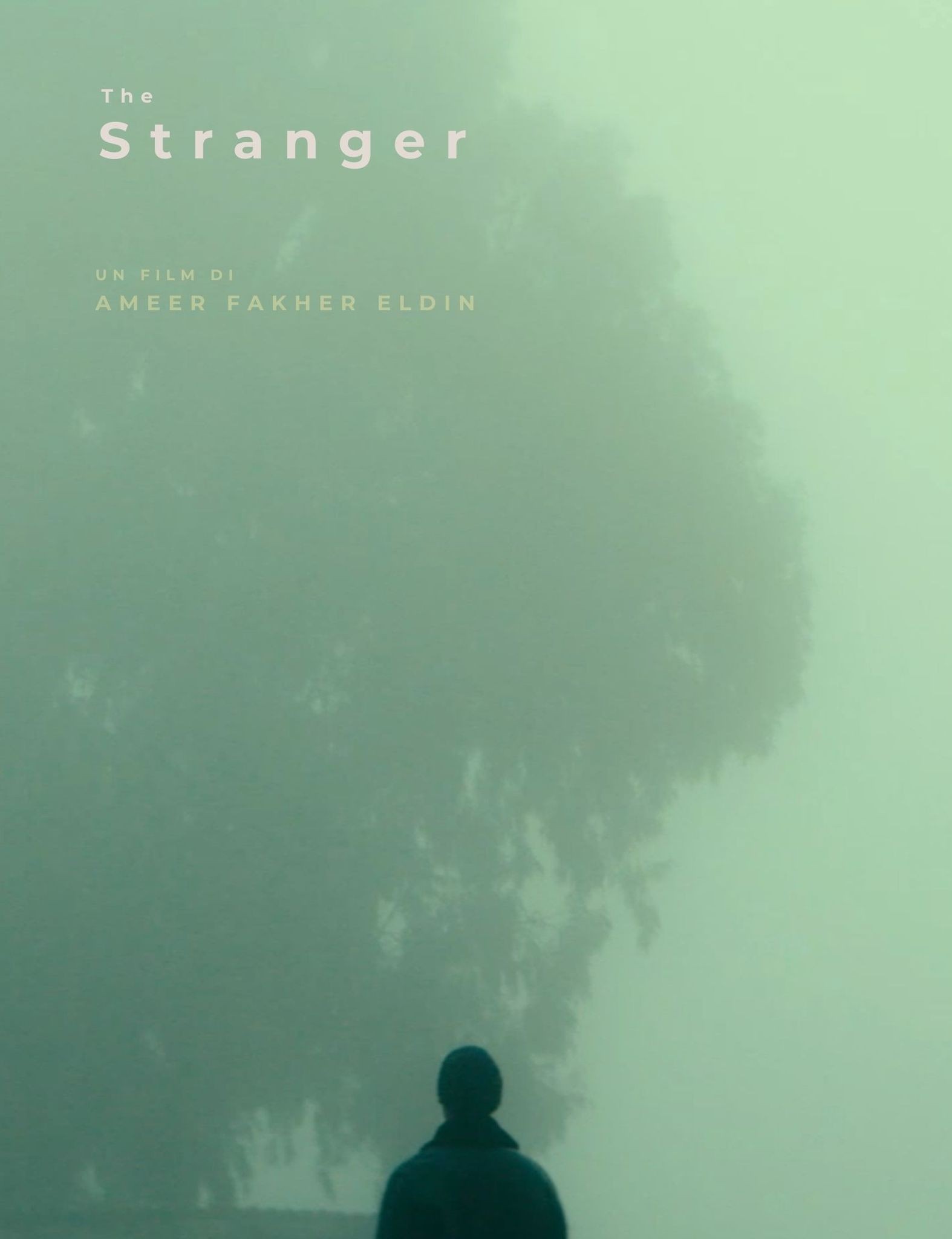
فُسْحَة: تحدّثت قبل بضعة شهور مع الناشط الجولانيّ وائل طربيّة عن «مهرجان أيّام الجولان الثقافيّة»، وكان اعتقاده أنّ الثورة السوريّة تسبّبت في انقطاع في العمل الثقافيّ وغياب للمشهد الثقافيّ الجولانيّ لما يقارب عقدًا كاملًا. لكنّ المهرجان، إضافة إلى نشاطات أخرى، شكّلت عودة إلى واقع الجولان المحتلّ بعيدًا عن الأزمة السوريّة، فهل «الغريب» جزء من استعادة المشهد الثقافيّ الجولانيّ؟
أمير: من المؤكّد أنّ المشهد الثقافيّ يمثّل فعل مقاومة هامّ في سياق الحفاظ على الهويّة. المشكلة الّتي تواجهنا في الجولان هي الزمن، فنحن لا نعاني من الاحتلال مثلما هو الحال في رام الله مثلًا، أي بشكل يوميّ، لكنّ معاناتنا تتعلّق بالزمن. قرأت مرّة شيئًا عن طنين الأذن الّذي يصيبنا أحيانًا لمدّة عشر دقائق قبل أن يختفي. إذ يتسبّب موت إحدى شعيرات الأذن بشعور بالألم الّذي يُنتج ذلك الصوت، قبل أن يقرّر الدماغ التلاعب بنفسه ويُصدر أمرًا بتحويل الطنين إلى هدوء لأنّه مكرّر ولا يتوقّف. ذلك يعني أنّ الدماغ يخدع نفسه لينسى ويُنهي المعاناة. هذه هي مشكلة الجولاني بطريقة أو بأخرى، وهي مشكلة الأجيال الّتي قد تختار النسيان على المعاناة، والتجاهل على مواجهة الذات ومشكلات الهويّة. هي مشكلة الزمن، وهنا تبرز أهميّة المشهد الثقافيّ الّذي هو في حدّ ذاته مَهمّة وليس فقط مهمًّا. تخيّل لو أنّ جيلًا يرفض أن يكون جسرًا للهويّة، فسيحكم على الأجيال القادمة أن تكون في حالة انقطاع تامّة عن جذورها.
كلّما مرّ الوقت على احتلال الجولان، ستواجه الأجيال القادمة تهديد الانفصال الجذريّ بيها وبين الوطن الأمّ سوريا. مع مرور الزمن يصبح الحفاظ على الهويّة أصعب، وكذلك الحفاظ على إرثك الحضاريّ، ويتطوّر شكل الاحتلال العسكريّ إلى احتلال معرفيّ، ولا تعود المشكلة في الجيب العسكريّ الّذي يمرّ دون التسبّب بأذى، بل في الاحتلال المعرفيّ الّذي يهدّد الهويّة الجولانيّة. من المؤكّد أنّ المشهد الثقافيّ يكشّل فعل مقاومة أساسيّ لهذا الاحتلال، أمّا الفيلم فلا أعرف إلى أيّ درجة يمكن أن يكون جزءًا من العودة، لكنّه وربّما لكونه أوّل فيلم روائيّ جولانيّ، وبسبب كلّ ما حدث معه حتّى الآن، وهو شيء أشعر بالفخر بسببه، خاصّة اختياره لتمثيل فلسطين في حفل «الأوسكار»، لهذا كلّه ربّما يتمكّن الفيلم من إلقاء الضوء بطريقة أو بأخرى على واقع الجولان الّذي يصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت.
فُسْحَة: بعض المراجعات النقديّة وصفت عدنان، الشخصيّة الرئيسيّة، بالشخصيّة اللامنتمية سياسيًّا، لكنّك وصفته بالشخصيّة المنتمية والوطنيّة أيضًا؛ فهل هو المنتمي أم اللامنتمي، وكيف تفهمه في كلتا الحالتين؟
أمير: إن سألتني عن التأويلات فهي من اختصاص المشاهد، لأنّني لا أستطيع فرض تفسيراتي الشخصيّة على أحد. لكنّني أعتبره شخصيّة منتمية؛ ففي نهاية الفيلم ثمّة مقطع شعريّ يُجيب على مشهد البداية الّذي يظهر فيه يقف وراء النافذة محدّقًا ويسمع أصوات الحرب السوريّة، بينما تقول له زوجته:"فرنسا؟ عندن خبز طيّب بفرنسا، باريس؟ ألمانيا؟"، وتقول له في النهاية "قديش الإنسان ممكن يعيش في ظلّ حدا ثاني". في نهاية الفيلم يظهر عدنان وهو يُلقي مقطعًا شعريًّا، ويبدو كأنّه يُجيب على أسئلة ليلى:"قد تثمر غراسنا يومًا/ وقد يبلغ أطفالنا المغنم/ ولكن، ألا تخشين يا ليلى أن تفقد الشجرة طعمها/ إن نمت في غير تربتها؟". هذا هو انتماء عدنان.
فُسْحَة: إذن ليس شخصيّة منتمية فحسب، بل مؤمنة كذلك؟
أمير: أجل، هو مؤمن بالمعاناة، بأنّه ليس من الضرورة الهرب منها. مرّة أخرى أعود إلى البداية، إلى أنّ الهجرة قد لا تكون هجرة المكان، بل هجرة الهويّة نفسها. هو يؤمن بأنّه لا يريد أن يفقد طعمه ولا هويّته، وهنا يكمن انتماءه. أنا لم أصنع فيلمًا وطنيًّا يتمحور حول خطاب وطنيّ مثل الخطاب البعثيّ الّذي احتكر الوطنيّة. مهمّة الفنّ هي اختزال الخطاب الوطنيّ ومعالجة وتنمية فكرة الانتماء والتأكيد على أهميّة، وعلى أنّ الانسلاخ عنها يعني انعدام القيمة، والمستقبل، والماضي. ثمّة نقد ذاتيّ لمهمّتنا كجيل في الحفاظ على هويّتنا، وعدنان يمثّل ذلك النقد في كيفيّة حفاظه على هويّته وإنسانيّته، وبشعوره بالمسؤوليّة عن تلك الهويّة.

كاتب وباحث ومترجم. حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسيّة، والماجستير في برنامج الدراسات الإسرائيليّة من جامعة بير زيت. ينشر مقالاته في عدّة منابر محلّيّة وعربيّة، في الأدب والسينما والسياسة.








